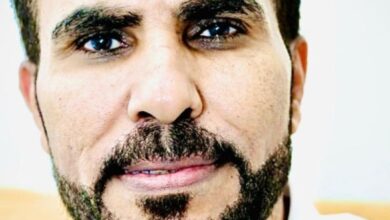الإنجاز بين الفرد والمجتمع (الجزء الرابع)

د/ عبدالجليل الخليفة
من المسؤول عن الإنجاز و صناعة الحضارة، هل هو الفرد أم المجتمع؟
استعرضنا في الجزء الأول النظرية الأولى وهي النظرية الرأسمالية، ثم تحدثنا في الجزء الثاني والثالث عن النظرية الثانية و هي الماركسية. وهذا الجزء الرابع هو تتمة الحديث عن الماركسية.
المادية التاريخية:
التاريخ في نظر الماركسية يشبه النهر، فرغم أنه يبدو ثابت الشكل حين تراه من مسافة بعيدة، إلا أن الماء يتدفق فيه باستمرار. فالتاريخ يتطور باستمرار تبعا للتغير المستمر في وسائل الإنتاج وتطور القوى المنتجة. وهذا التغيير المتواصل في وسائل الإنتاج يتبعه تغير مستمر في علاقات الإنتاج، وكذلك تتغير البنية الفوقية كالأفكار وغيرها، فكل مرحلة إنتاج تستخدم وسائل إنتاج معينة، وتسود فيها علاقات إنتاج مناسبة لها، ولكنها تحمل نقيضها في داخلها. وحين تتغير وسائل الإنتاج يحدث الصراع بين النقيضين، وهما: – طبقة المستفيدين من علاقات الإنتاج الحالية والتي تسعى لبقاء الوضع الراهن، – وطبقة الساعين إلى التغيير، وهم من سيستفيد من علاقات الإنتاج الجديدة. ونتيجة لهذا الصراع الطبقي يبدأ التغيير تدريجيا، ثم يتطور فجأة هذا التغيير الكمي إلى تغيير نوعي، فيولد النظام الجديد من علاقات الإنتاج الجديدة، التي تتناسب مع وسائل الإنتاج الجديدة.
إن وسائل الإنتاج في أي مرحلة تاريخية تؤسس علاقات إنتاج تتناسب معها. وعند حدوث تغيير في وسائل الإنتاج تصبح علاقات الإنتاج الحالية حجر عثرة ومانعا للتطور، وعندها يبدأ التنافر بين علاقات الإنتاج الحالية وبين وسائل الإنتاج الجديدة، التي تحاول أن تؤسس لعلاقات إنتاج جديدة. ويشتد الصراع الطبقي، بين الطبقة المستفيدة من علاقات الإنتاج الحالية، والتي تريد الحفاظ على الوضع القائم ، وبين الفئة الاجتماعية التي تؤيد التغيير لأنها ستستفيد من وسائل الإنتاج الجديدة. ونتيجة هذا الصراع، يبدأ التغيير تدريجيا لمدة من الزمن، حتى يصل إلى مرحلة يصبح التغيير فيها نوعيا، فتسقط علاقات الإنتاج القديمة، لتحل محلها علاقات الإنتاج الجديدة. وهكذا تستمر التغيرات في تاريخ البشرية بناء على قوانين الجدل الثلاثة المذكورة سابقا.
و لننظر إلى الاقتصاد الرأسمالي كمثال:
استفاد أصحاب رؤوس الأموال كثيرا من الصناعة والماكينة، كوسائل إنتاج، طيلة القرنين الماضيين، وراكموا ثروات طائلة، من فائض قيمة المنتجات المباعة، بينما بقيت الطبقة العاملة تعيش على أجورها. وتتكون علاقات الإنتاج الحالية من الملكية الفردية، و مبدأ (الأرباح أولا) الذي تطبقه الشركات المدرجة في الأسواق العالمية المفتوحة. وعند حدوث أي هزة اقتصادية، يتعرض الآلاف من العمال للتسريح، وتتبخر مدخرات الملايين من صغار المستثمرين لصالح طبقة الأغنياء. وقد تكونت نتيجة ذلك طبقية فاحشة بين: – الطبقة البورجوازية الرأسمالية كما تسميها الماركسية وهي طبقة ملاك رؤوس الأموال وبين – طبقة البروليتاريا كما تسميها الماركسية و هي الطبقة العاملة.
ترى الماركسية طبقا لمبدأ الجدلية أن نقيض البورجوازية الرأسمالية هي البروليتاريا، وهي موجودة معها في النظام الرأسمالي، فلا غنى للبورجوازية عن البروليتاريا للعمل في مصانعها، واستهلاك منتجاتها. وحين يشتد الصراع الطبقي بين البورجوازية والبروليتاريا يحدث التغيير الكمي تدريجيا، حتى يصل إلى مرحلة الانفجار، وهو التغير النوعي. وعندها تستولي طبقة البروليتاريا على النظام الإنتاجي، ووسائل الإنتاج، وتؤسس لمرحلة جديدة، وهي مرحلة الاشتراكية في خطوة تمهيدية للشيوعية المطلقة. وبذلك تتأسس علاقات الإنتاج الجديدة، وهي الملكية المشاعة، حيث تلغى الملكية الفردية، وتنتفي الحاجة لسلطة الدولة. هذه هي الجنة التي وعدت بها الماركسية، والتي ينتهي فيها الصراع الطبقي، إذ تنشر طبقة البروليتاريا العدل و الرفاه، ولا يوجد نقيض يتصارع معها. وتكون علاقات الإنتاج عندها طبقا لقانون (من كل حسب طاقته، ولكل حسب حاجته)، وتختفي بذلك الملكية الفردية بتاتا.
الخلاصة، ترى الماركسية ما يلي:
يبدأ التغيير في البنية التحتية، وهي وسائل وعلاقات الإنتاج، و منها ينتقل التغيير إلى البنية الفوقية، وهي: الأفكار والأديان والأخلاق والفنون. وهذه ترجمة عملية لمادية (فيورباخ)، والتي تتبنى المادة كصانعة للأفكار، وليس العكس. فكل فكر وفن يتبناه الإنسان هو مصبوغ ومؤسس بناء على علاقات الإنتاج، وليس لأي سبب آخر.
يتأثر الإنسان بعلاقات الإنتاج، فيكون إما مع علاقات الإنتاج السابقة أو مع علاقات الإنتاج الجديدة، أي يكون مثلا إما مع البورجوازية أو مع نقيضتها البروليتاريا. وهذا يعني أنه يتأثر بالطبقة الاجتماعية وعلاقاتها و مصالحها. فالأصل أن الطبقة الاجتماعية هي التي تؤثر في الفرد. فمثلا إن كان مع البورجوازية الرأسمالية فسيدعم الملكية الفردية، وإن كان مع البروليتاريا فسيدعم الملكية المشاعة، التي تتناسب مع أهدافها. وتتوقف عجلة الجدلية بانتصار البروليتاريا وانتهاء الرأسمالية، فتبقى بلا نقيض.
وهكذا فالصراع الاجتماعي والحركة التاريخية يعتمدان على تغير وسائل الإنتاج فقط، دون أي سبب آخر.
يجدر بنا أن نقيم النظرية الماركسية من الناحية الفكرية ومن الناحية العملية:
الناحية الفكرية:
يولد الإنسان بفطرة تحب العدالة والفضيلة والجمال، وبحب الذات بغض النظر عن المرحلة التاريخية أو الطبقة الإجتماعية. ولا دليل على أن وسائل الإنتاج وعلاقاتها هي التي تؤسس لهذه الأمور.
برز في التاريخ آلاف الأنبياء والمصلحين، ودعاة الحق والفضيلة، الذين غيروا مسار التاريخ، وكان التغيير الاقتصادي، وعدالة التوزيع، والرفاه، نتيجة وليس أساسا. (الأفكار صنعت الواقع الاقتصادي وقننت علاقات الإنتاج في بعض التجارب التاريخية)، إن حصر أسباب التطور التاريخي والاجتماعي، في تغير وسائل الإنتاج كما تدعي الماركسية، لا يمكن إثباته فلسفيا ولا علميا. فهناك مثلا تقدم علمي في الطب أدى إلى إنخفاض الوفيات، وتحسن الوضع الصحي، والتحكم في الإنجاب، مما حقق تطورا تاريخيا اجتماعيا، وهذا التقدم العلمي لم يكن نتيجة لاستخدام وسيلة إنتاج معينة.
إن تقسيم الأمور إلى بنية تحتية (من وسائل وعلاقات الإنتاج) وجعل (الأفكار والأخلاق والأديان والفنون) كبنية فوقية، تابعة ومتأثرة ومصبوغة بالبنية التحتية، لم يقم عليها دليل فلسفي أو علمي. ونحن نعرف أن البشر منذ عهد آدم اتفقوا على جمال الصدق والأمانة والشجاعة والكرم والأخلاق الفاضلة، وأحبوا الفنون كالرسم، رغم تغير وسائل الإنتاج عبر التاريخ. فكيف تغيرت البنية التحتية وبقيت البنية الفوقية ثابتة.
يجدر بنا أن نسأل: هل النظرية الماركسية من علاقات الإنتاج فهي من البنية التحتية، أم هي من الأفكار الأخرى فتكون من البنية الفوقية؟
إن كانت الماركسية من علاقات الإنتاج فلا بد أن تتغير بتغير وسائل الإنتاج، وإن كانت من البنية الفوقية فهي ناتجة عن البنية التحتية، ولا تحكم عليها. فالنظرية الماركسية حكمت على نفسها إما بالتغير وعدم الثبات مع تغير وسائل الإنتاج إن كانت من البنية التحتية، أو عدم الصلاحية كنظرية ثابتة وحاكمة إن كانت من البنية الفوقية.
إن كانت الجدلية قانونا مضطردا، فأين النقيض عندما تنتصر البروليتاريا وتتحقق الشيوعية؟ فإن كانت الجدلية مضطردة، فلا بد أن تحمل الشيوعية نقيضها، وهذا سيؤدي إلى زوالها والقضاء عليها.
تعتمد نظرية دارون المادية للانتخاب الطبيعي على تأقلم الكائنات مع تغيرات الطبيعة، وهي تعبير واضح عن حب الكائنات للبقاء (أي حب الذات)، فلو افترضنا جدلا صحة نظرية دارون (تنزلا مع مادية فيورباخ و ماركس)، فكيف غاب حب الإنسان لذاته، المتمثل في حب التملك، عن نظرية ماركس.
الناحية العملية:
الماركسية فلسفة تاريخية اجتماعية اقتصادية، لم تثبت علميا في المختبرات بالتجربة والملاحظة، ولكنها نظرية طبقت لمدة قرن من الزمن، ونستطيع الآن أن نستعرض تاريخها ونتائجها العملية التالية:
– كان تطبيق الماركسية دمويا، ذهب ضحيته عشرات الملايين في الاتحاد السوفيتي.
– لم تنجح الشيوعية في هدم الدين في دول وسط آسيا، رغم جهودها التي امتدت لعشرات السنين، فلو كان الدين من البنية الفوقية كما تقول الماركسية، لأمكن هدمه، بجهود أيسر، وبوتيرة أسرع.
– لم تنجح الماركسية، ولم يحدث الصراع الطبقي في العالم الغربي، بل اتخذت الرأسمالية بعض الإصلاحات، و أعطت العمال بعض حقوقهم، فانحسر بذلك المد الماركسي.
– أصطدمت الماركسية بالواقع، وهو فطرة الإنسان التي جبلت على حب التملك، فانخفضت الإنتاجية، وانهارت الشيوعية في الإتحاد السوفيتي، وشرق أوروبا، وانهار جدار برلين. أما الصين فقد تبنت أخيرا نظاما رأسماليا، يسمح للشركات الخاصة بتملك بعض وسائل الإنتاج، ويشجع التجارة العالمية، وكذا روسيا التي تبنت أخيرا بعض الأنظمة الرأسمالية.
لا نملك بعد مراجعة الملاحظات الفكرية والعملية، إلا أن نستنتج فشل النظرية الماركسية في تحفيز الإنجاز و تحقيق العدالة الإنسانية. فقد حاولت الماركسية معالجة سلبيات الرأسمالية، كالطبقية والهزات الاقتصادية، وأن تعطي الطبقة العاملة حقوقها، إلا أنها وبكل أسف سحقت حرية الأفراد، وسلبتهم الحافز الداخلي للإنجاز، وهذه خسارة عظمى، امتدت قرنا من الزمن.
تبين فيما سبق، أن النظرية الماركسية ترى أصالة المجتمع، والعلاقات الإجتماعية التي تحكم الأفراد، وذلك على النقيض من الرأسمالية، التي ترى أصالة الفرد.
وتبين أيضا، كم خسرت البشرية طيلة القرون الماضية، نتيجة عدم نجاح هاتين النظريتين، في بسط العدالة والرفاهية. وبقي أن نستعرض النظرية الثالثة مستقبلا إن شاء الله.